خالد السيد يكتب .. التحكيم في الاسلام وحكمه


حكم التحكيم الجواز عند جمهور الفقهاء، ولم تختلف المذاهب في أصل مشروعيته لما سبق من الأدلة والقياس على القضاء والاستفتاء، وإنما اختلافهم فيما قد يحتاجه من قيود وشروط.
قال المازري المالكي: "تحكيم الخصمين غيرهما جائز، كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما"، وجزم أبن فرحون بالجواز فقال: "إذا حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جوارا بينا".
ونصوص المذاهب ظاهرة متضافرة على جوازه غاية ما هنالك أن المالكية اختلفوا في جوازه ابتداء أو بعد وقوعه، وظاهر كلامهم، ومفهومه جواز التحكيم ابتداء.
والحنفية امتنعوا عن الفتوى به مع جوازه خشية أن يتجاسر العوام إلى تحكيم من ليس أهلًا فقالوا: "إن حكم المحكم في المجتهدات نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر المذهب عن أصحابنا، إلا أن هذا مما يعلم، ولا يفتى به كي لا يتجاسر الجهال إلى مثل هذا".
إلا أن واقع المذهب أن لو كان المحكم على وفق ما ذكروه من شروط وفي محل الاجتهاد جاز ومضى حكمه، حتى قالوا: "إن فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى، أو حكم المحكم".
والشافعية مع القول بجوازه "بشرط أهلية القضاء فلم يجوزوا تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي ولو قاضي الضرورة".
وعند الشافعية قول بعدم الجواز لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم وقول بجوازه بشرط عدم وجود قاض بالبلد وهذا هو المعتمد، ولو لغير الأهل، فيمتنع تحكيم غير الأهل، مع عدم وجود قاضي الضرورة إلا إن كان يأخذ مالًا له وقع بحيث يضر حال الغارم فيجوز التحكيم، وإن كان القاضي مجتهدًا، وسيأتي تقسيمات مذهبهم تبعًا لمحل التحكيم.
والعلاقة بين التحكيم والقضاء علاقة متأصلة فالتحكيم من الولايات فهو نوع من القضاء لما فيه من فصل الخصومة، وبيان الحكم الشرعي، فالحكم من أنواع القضاء، ولذلك يذكر الفقهاء التحكيم والحكم في باب القضاة أو القضاء.
فيتفقان في الإلزام بحكمهما إلا أن القضاء بمثابة الأصل، والتحكيم بمحل الفرع منه فرتبته أقل وأدنى ولذا اختلف القضاء عن التحكيم في أمور أهمها:
موضوع القضاء في الخصومات مطلقا وفي كل ما يعرض عليه، وحكم المحكم لا يصح في الحدود والقصاص والدية على العاقلة.
ولاية القضاء عامة على الناس، فولايته من ولي الأمر، ومعين من قبله فعمله من المناصب والولايات، وولاية المحكم خاصة فيمن ارتضاه من المتخاصمين "فولاية التحكيم بين الخصمين ولاية مستفادة من آحاد الناس، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص"، وقال الشافعي: "التحكيم إنما هو فتوى لأنه لا يقدم آحاد الناس الولاة والحكام"، فينفذ حكم القاضي على العامة وينفذ حكم المحكمين على مـن رضي بحكمهما.
حكم المحكم يصح فيما يملك المحكمون فعله بأنفسهم، وهي حقوق العباد، ولا يصح في حقوق الله.
يجوز تحكيم أثنين أو أكثر، ولا بد حينئذ من اجتماعهم، فلو حكم أحدهم دون غيره لا يجوز لأن المحكمين رضيا برأيهما أو رأيهم، وهذا بخلاف القضاء.
إن حكم المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقًا لرأيه أمضاه، وإن كان مخالفًا أبطله – عند بعض الفقهاء – وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات.
شروط القضاة يضعها ولي الأمر كما قررها الفقهاء، بينما شروط المحكم يضعها المتخاصمون مع مراعاة بعض الشروط التي يتفق فيها مع شروط القاضي –على تفصيل في ذلك عند الفقهاء-.
يجوز للمتخاصمين أن يوقفوا التحكيم قبل الشروع فيه أو قبل صـدور الحكـم –على خلاف فيه– كما أن لهما أن يعزلا المحكم، بخلاف القضاء.
وما بين التحكيم والإفتاء وإن اتفق مع الإفتاء في الإخبار عن الحكم الشرعي في الواقعة محل النزاع أو محل السؤال إلا أن التحكيم ألصق بالقضاء لصفة الإلزام عند جمهور الفقهاء، وليس كذلك صفة الإفتاء ولذا اختلف عن التحكيم في جوانب جوهرية، فاشترط كثير من الفقهاء في المحكم ما يشترط في القاضي دون اشتراط ذلك في المفتي، فالمفتي يخبر عن حكم الواقعة محل السؤال، والقاضي والمحكم ملزم ومنشئ للحكم في الواقعة محل النزاع، والتحكيم محدد في مسائل من النزاع والخصومة وغيرها قال ابن فرحون: "العبادات لا يدخلها الحكم بل الفتيا فقط"، وبمثـل ذلـك قـال القرافـي وزاد قوله: "فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط، فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة"، وقد عدد القرافي مسائل من باب الفتوى وأخرى من باب الحكم.
ويشترط في التحكيم أن يكون موافقا للشرع بأن يكون بالبينة أو الإقرار أو التوكـل ونحو ذلك.
ويشترط في المحكم بالكسر العقل، ولا يشترط الحرية والإسلام، فيصح تحكيم ذمي ذميًا وقال الشافعية: يشترط في المحكمين أن يكونا راشدين يتصرفان لأنفسهما، وليس المحكم أصلًا ولا فرعًا لأحدهما ولا عدوًا له.
ويتفق الفقهاء في جملة الشروط وبخاصة أن يكون المحكم أهلًا للقضاء أو الشهادة، إلا أنهم يختلفون في بعض الشروط وفي تفصيلها:
فيشترط الحنفية أن يكون الحكم أهلًا للحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أهلًا للقضاء، فلو انتخب الخصمان صبيًا وحكم في حال صباه، أو بعد البلوغ بناء على التحكيم السابق فلا يصح حكمه ولا ينفذ. وعبر صاحب الفتاوى الهندية باشتراط أن يكون الحكم من أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت الحكم، حتى إنه إذا لم يكن أهلًا فأعتق، أو ذميًا فأسلم وحكم لا ينفذ حكمه.
واشتراط الشهادة أدخل تحكيم المرأة والفاسق، لأنهما من أهل الشهادة وصلاحيتهما للقضاء والأولى عندهم عدم تحكيم الفاسق، وكذا الكافر في حق الكافر، لأنه أهل للشهادة في حقه، وكذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة، وجاز لذلك تحكيم ذمي ذميًا لأنه من أهل الشهادة بين أهل الذمة دون المسلمين. ويكون تراضيهما عليه في حقهما وجوازه قياسا على جواز تقليد السلطان للذمي ليحكم بين أهل الذمة، فإذا جاز في القضاء جاز في التحكيم لأن المحكم كالقاضي، ولا يصح تحكيم كافر في حق مسلم أو عبد محجور عليه أو محدود في قذف أو صبي لأنهم ليسوا من أهل الشهادة.
كما اشترطوا في المحكم أن يكون معلومًا، فلو كان حكمًا مجهولًا كأول من يدخل المسجد لم يجز، وألا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع من الشهادة.
واشترط المالكية أن يكون عدلًا، عدل شهادة بأن يكون مسلمًا، حرًا، بالغًا، عاقلًا، غير فاسق وقال اللخمي: "إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد"، وقال المازري: "لا يحكم إلا من يصح أن يولى القضاء"، وأن يكون غير خصم أي غير أحد الخصمين، لأن الشخص لا يحكم لنفسه ولا عليها وغير خصم لأحدهما بأن ثبت بينه وبين أحد المتداعيين خصومة دنيوية، وإن لم تصل إلى العداوة.
فإن وقع تحكيم الخصم مضى إن حكم صوابًا، وقيل: يجوز ابتداء عند ابن عرفه، فإن كان الخصم من تولية قاض صح حكمه.
كما اشترطوا أن يكون المحكم غير جاهل بالحكم بأن يكون غالبًا عالمًا بما حكم به إذ شرط الحاكم والمحكم العلم بما يحكم به، وإلا لم يصح، ولم ينفذ حكمه بالجهل لأنه تخاطر وغرر، لكن لو شاور الجاهل العلماء وحكم فيصح، وينفذ، ولا يقال له حينئذ حكم جاهل.
وكذا حكم العامي قال اللخمي: "يجوز تحكيمه إذا استرشد العلماء، فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل، لأن ذلك تخاطر وغرر، كما لا يجوز تحكيم غير مميز لجنون أو وسوسة أو إغماء".
واختلف المالكية في تحكيم صبي وعبد وامرأة وفاسق فيما يصح فيه التحكيم أي في المال والجُرح على أربعة أقوال: الصحة مطلقا، وهو لأَصبَغ، وعدم الصحة مطلقا، وهو لمُطَرِّف ومقتضى قول المازري والثالث الصحة إلا في تحكيم الصبي المميز، لأنه غير مكلف ولا إثم عليه إن جاز وهو لأشهب، والرابع الصحة إلا في تحكيم الصبي الفاسق وهو لعبد الملك.
وعلى هذا فجمهور المالكية على جواز تحكيم المرأة والعبد، وهم بهذا يتفقون مع الحنفية في صحة تحكيم المرأة، واشترط الشافعية أهلية المحكم للقضاء، ولكنهم اختلفوا في المراد بالأهلية هل هي الأهلية المطلقة أي العلم بحكم سائر المسائل، أو العلم بحكم المسألة محل النزاع فقط، فقال الزركشي: "المراد الأهلية المطلقة لا بالنسبة لتلك الحادثة فقط"، قال: ونقل في الذخائر الاتفاق على ذلك من المجوزين للتحكيم، وقال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط.
واختلفوا في تحكيم غير الأهل فالمعتمد عندهم: أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مطلقا، ولو مع وجود قاضي الضرورة إلا في النكاح إذا فقدت القاضي، وكانت المرأة في سفر فولت أمرها عدلا يزوجها وإلا إذا ترتب على الرفع لقاضي الضرورة غرامة مال على الحكم، يشق عليه عادة ولا يحتمله مثله فإن فقد القاضي مطلقا حتى قاض الضرورة كالفاسق، واحتيج إلى الحاكم جاز تحكيم أصلح وأفضل من يوجد من العدول بخلاف غيرهم.
وبشرط أهلية القضاء لا يجوز تحكيم الأعمى ولا الأصم ولا المرأة ولا الخنثى ولا الرقيق ولا الكافر ولو في خصم كافر وكذا لا يجوز في نحو ولده، ومن يتهم في حقه، ولا على عدوه. وقال ابن أبي الدم: لو تحاكم إليه بالتحكيم ولده، وأجنبي، فحكم لولده، أو لوالده على الأجنبي ففي جوازه وجهان، أحدهما: لا يجوز كالقاضي المطلق، والثاني بلى؛ لأن ذلك وقع عن رضا بينهما وهكذا لو حكم على عدوه، فيه وجهان أيضا.
وللشافعية تفصيل وخلاف ذكره الماوردي فقال: إن كان التحكيم من المتنازعين لمن لا يجوز أن يشهد لهما ولا عليهما – والذي لا يجوز أن يشهد لهما والد وولد، والذي لا يجوز أن يشهد عليهما عدو – فينظر: فإن حكم على من لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد لمن يجوز أن يشهد له من الأجانب جاز، كما يجوز أن يشهد عليه وإن لم يجز أن يشهد له.
وإن حكم لمن لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد على من يجوز أن يشهد له من الأجانب ففي جوازه وجهان:
أحدهما: لا يجوز حكمه له، كما لا يجوز أن يحكم له بولاية القضاء.
والثاني: يجوز أن يحكم له بولاية التحكيم وإن لم يجزأن يحكم له بولاية القضاء؛ لأن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهما فصار المحكوم عليه راضيا بحكمه عليه، وخالفت الولاية المنعقدة بغير اختيارهما وإن حكم لعدوه نفذ حكمه، وإن حكم على عدوه ففي نفوذ حكمه عليه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء ولا بولاية التحكيم كما لا يجوز أن يشهد عليه.
الوجه الثاني: يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء، وولاية التحكيم، بخلاف الشهادة، لوقوع الفرق بينهما، بأن أسباب الشهادة خافية وأسباب الحكم ظاهرة.
الوجه الثالث: أنه يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم لانعقادها عن اختياره ولا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء لانعقادها بغير اختياره.
كما اشترط الشافعية في المحكم أن يتفق الخصمان على التراضي به إلى حين الحكم، فإن رضي به أحدهما دون الآخر، أو رضيا به ثم رجعا، أو رضي أحدهما بطل تحكيمه، ولم ينفذ حكمه سواء حكم للراضي أو للراجع.
ويمكن تأصيل قاعدة ما لا يجوز التحكيم فيه عند المذاهب فيما يلي:
عند الحنفية: كل ما كان حقا لله تعالى، أو في كل مالا ولاية للمحكمين عليه.
عند المالكية: كل ما كان حقا لله تعالى، أو تعلق به حق غير الخصمين.
وعند الشافعية: كل ما كان حقا لله تعالى خالصا، أو عقوبة له عز وجل أو في كل ما ليس له طالب معين، وأضافوا النكاح واللعان ربما لتعليل المالكية في تعلق الحق بغير الخصمين.
وعند الحنابلة: في كل ما كان حقا لله خالصا، مع إضافة النكاح واللعان للتعليل السابق.
وفيما يلي بيان مذاهبهم:
عند الحنفية: لا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص، والدية على العاقلة وقال بعض الحنفية: إن هذا في الحدود الخالصة حقا لله تعالى، لأن الإمام هو المتعين لاستيفائها، وليس للمحكمين ولاية على سائر الناس ولذلك جاز التحكيم في القصاص في إحدى الروايتين عند الحنفية، وجاز في حد القذف لأنهما من حقوق العباد.
والإمام أبو حنيفة على عدم الجواز في القصاص، ولكن قال الجصاص: ينبغي أن يجوز وعلل ذلك، بأن ولي القصاص لو استوفى القصاص من غير أن يرفع إلى السلطان جاز، فكذا إذا حكم فيه؛ لأنه من حقوق بني آدم، والصحيح عندهم عدم جواز التحكيم في الحدود والقصاص؛ لأن حكم الحكم بمنزلة الصلح، ولا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف بالصلح؛ لأنه لا ولاية لهما على دمهما؛ ولأنهما يندرئان بالشبهات، وفي حكم المحكم شبهة، لأنه حكم في حقهما لا في حق غيرهما وهذه شبهة عظيمة.
وأما عدم جوازه في الدية على العاقلة؛ لأنه لا ولاية لهما على العاقلة، فلو حكماه في دم الخطأ فقضى بالدية على العاقلة، أو على القاتل في ماله لا ينفذ حكم من حكماه على العاقلة، ولا على القاتل أما الأول: فلعدم التزام العاقلة حكمه وعدم رضا العاقلة به، وحكم المحكم إنما ينفذ على من رضي بحكمه، ولكن لو أن العاقلة حكموه نفذ حكمه لولايته عليهم حينئذ.
وأما الثاني: فلكونه مخالفا لحكم الشرع؛ لأن الدية تجب على العاقلة لا على القاتل، لكن لو أن القتل ثبت بإقرار القاتل، أو ثبت جراحته ببينة وأرشها أقل مما تتحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة خطأ أو عمدا، أو كان قدر ما تتحمله العاقلة، ولكن الجراحة كانت عمدا لا توجب القصاص نفذ حكمه عليه؛ لأن العاقلة لا تعقله .
عند المالكية: حدد المالكية ما لا يجوز التحكيم فيه في الحدود مثل حد القذف والزنا والسرقة والسكر والجلد والرجم، والقصاص في النفس، كما نصوا على عدم جواز التحكيم في قتل في ردة أو حرابة؛ لأنه حق لله لتعدي حرماته، وكذا تارك الصلاة، ولا في عتق ولا في ولاية لشخص على آخر، ولا في نسب كذلك، ولا طلاق وأيضا لا يجوز التحكيم في فسخ لنكـاح ونحـوه، ولا فـي رشـد وسفـه ولا في أمر غائب مما يتعلق بما له، وزوجته، وحياته، وموته، ولا في حبس، ولا في عقد مما يتعلق بصحته وفساده؛ لأن هذه الأمور إنما يحكم فيها القضاة، فلا يجوز التحكيم فيها لتعلق الحق بغير الخصمين، إما لله تعالى كالحدود لأن المقصود منها الزجر وهو حق لله تعالى، والقتل لأنه إما لردة أو حرابة وكله حق لله لتعدي حرماته، والعتق، لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرق ولو رضي بذلك، وكذا الطلاق البائن لا يجوز رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك فالطلاق فيه حق لله تعالى إذ لا يجوز أن تبقى المرأة المطلقة البائن في العصمة.
وأما لآدمي كاللعان والولاء والنسب، ففي اللعان حق الولد في نفي نسبه من أبيه، وفي الولاء والنسب ترتيب أحكامها من نكاح وعدمه، وإرث وعدمه، وغير ذلك على الذريـة التي ستوجد فلا يسري ذلك على غير المحكمين، ومن يسري ذلك إليه لم يرضى بحكم المحكم.
عند الشافعية: عدم جواز التحكيم في الحدود، وبتعبير أشمل عدم الجواز فيما هو عقوبة لله تعالى ليتناول التعزير، وفي قول لا يجوز في قصاص ونكاح ونحوهما كاللعان وحد قذف وعللوا ذلك بخطر أمرها فتناط بنظر القاضي ومنصبه.
وعللوا لعدم جواز التحكيم في حدود الله تعالى بأن ليس لها طالب معين، وعليه فحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز فيه التحكيم.
عند الحنابلة: ظاهر كلام أحمد كما قال أبو الخطاب أن التحكيم في ما يتحاكم فيه الخصمان، وقال القاضي: يجوز حكم المحكم في الأموال خاصة، فأما النكاح والقصاص وحد القذف فلا يجوز التحكيم فيها لأنها مبنية على الاحتياط فيعين للحكم فيها قاضي الإمام كالحـدود، وفـي المغنى قال القاضي: ينفذ حكم من حكماه في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء: النكاح، واللعان، والقذف والقصاص، لأن لهذه الأحكام ميزة على غيرها فاختص الإمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه: خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار.











.jpg)


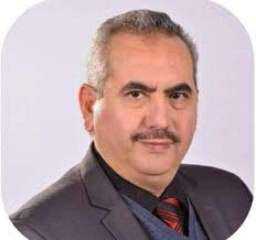


















.png)
