الدكتور عادل عامر يكتب: النفس الإنسانية في القرآن الكريم


قبل الحديث عن النفس كما هو مطلب البحث هنا، نُشِير أولًا إلى تعريفِ النفس في اللغة والاصطلاح، وقد ذكر أهل اللغة العربية للنفس كثيرًا من المعاني، بعضها له صلةٌ بما أريد الإشارة إليه، وهو الحديث عن النفس الإنسانية التي تُكوِّن الشخصية وتؤثر في سلوكها، وبعضها الآخر بعيدٌ عمَّا وددتُ الإشارة إليه، وسوف أكتفي هنا بذكر بعض هذه المعاني تحت العنوان التالي:
النفس بين اللغة والاصطلاح وألفاظ القرآن:
بعض تعريفات النفس في اللغة:
أولًا: النفس بمعنى الروح، يقال: خرجت نَفْس فلان؛ أي: روحه[1]، ومنه قولهم: فاضَتْ نَفْسه؛ أي: خرجت روحه[2].
ثانيًا: النفس بمعنى "حقيقة الشيء وجملته، يقال: قتل فلانٌ نَفْسه؛ أي: ذاته وجملته، وأهلك نَفْسه؛ أي: أَوقَع الإِهلاك بذاته كلِّها[3]، ومنه قول صاحب الصحاح "والتكبر: هو أن يرى المرء نَفْسه أكبر من غيره"؛ أي: ذاته[4].
ثالثًا: النَّفْس بمعنى "الحسد، والعين، يقال: أصابته نَفْسٌ؛ أي: عَيْن[5]، والنافس العائن.
رابعًا: النفس بمعنى الدم، وذلك أنه إذا فُقِد الدم من الإنسان فَقَد نَفْسه؛ أو لأن النَّفْس تخرج بخروجه، يقال: سالت نفسه، وفي الحديث: ((ما ليس له نفس سائلة لا يُنجِّس الماء إذا مات فيه))[6].
خامسًا: النفس ما يكون به التمييز، والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين؛ وذلك أن النَّفْس قد تأمره بالشيء وتنهَى عنه، وذلك عند الإقدام على أمر مكروه، فجعلوا التي تأمره نَفْسًا، وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى[7].
سادسًا: النَّفْس بمعنى الأخ[8]، وشاهده قول الله تعالى: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: 61].
وجمع النفس: أنفُس ونفوس، أما النَّفَس، فهو خروج الهواء ودخوله من الأنف والفم، وجمعه أنفاس، وهو كالغِذاء للنَّفْس؛ لأن بانقطاعه بطلانَها.
تعريف النفس في الاصطلاح:
قال صاحب كتاب التعريفات: "النَّفْس هي الجوهر البخاريُّ اللطيف، الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية، وسماها الحكيم: الروح الحيوانية، فهو جوهرٌ مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه، وأما في وقت النوم، فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه"[9].
تعريف النفس عند العلماء المعاصرين:
ذكر العلماء المعاصرون للنفس عدةَ تعريفات؛ منها: أن النفس "هي جوهر الإنسان، ومحرك أوجه نشاطه المختلفة؛ إدراكيةً، أو حركية، أو فكرية، أو انفعالية، أو أخلاقية؛ سواء أكان ذلك على مستوى الواقع، أو على مستوى الفهم، والنفس هي الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التأثير المستمر والتأثر، مكونين معًا وحدةً متميزة نطلق عليها لفظ (شخصية) تُميز الفرد عن غيره من الناس، وتؤدي به إلى توافقه الخاص في حياته"[10].
معاني النفس في القرآن الكريم:
وردت (النَّفْس) في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وتعدَّدت معانيها بحسب سياق الآيات الكريمة الواردة فيها، ومن هذه المعاني:
أولًا: النفس بمعنى الرُّوح، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 44]؛ أي: تتركون، ويقال: خرجت نَفْسه، خرجت رُوحه، والدليل على أن النفس هي الروح قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: 42]؛ يريد الأرواح[11].
ومنه قوله تعالى: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ [الأنعام: 93]، ولك أن الكافر إذا احتُضِر بشَّرتْه الملائكة بالعذاب والنكال، والأغلالِ والسلاسل، والجحيم والحميمِ، وغضب الرحمن الرحِيمِ، فتتفرَّق رُوحه في جسده، وتعصى وتأبَى الخروج، فتَضْرِبهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهم: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: 93]؛ أي: اليوم تُهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذِبون على الله، وتستكبرون عنِ اتِّبَاعِ آياته، والانقياد لرسله[12].
ثانيًا: النفس بمعنى الإنسان؛ أي: الشخصية البشرية بكامل هيئتِها، وهي الإنسان بكامل دمه ولحمه وشخصيته، وهذا كثير وغالب في القرآن، فمِن ذلك الآيات التالية:
قال الله تعالى مخاطبًا الناس عامة وبني إسرائيل خاصة، بأن يحذروا يوم الحساب ويعملوا صالحًا، وأن الإنسان يأتي ربه في ذلك اليوم فردًا ولا تنفعه شفاعة الشافعين: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: 48]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: 145].
وقد شاع استعمالُ النَّفْس في الإنسان خاصة؛ حيث تطلق ويراد بها هذا المركَّب والجملة المشتملة على الجسم والروح[13]، ويظهر هذا في غيرِ ما سَبَق، في قوله تعالى أيضًا: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص: 33]، والمقصود هنا الرجلُ الذي قتله موسى عليه السلام في أرض مصر؛ يعني الرجل القبطي.
ثالثًا: النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان (العقل):
ومنه قوله تعالى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: 116]؛ قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: "والنَّفْس تُطلَق على العقل وعلى ما به الإنسان إنسان، وهي الروح الإنساني، وتطلق على الذات، والمعنى هنا: تعلم ما أعتقده؛ أي: تعلم ما أعلمه؛ لأن النفس مقرُّ العلوم في المتعارف، وإضافة النفس إلى اسمِ الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطَّلِع عليه غيره؛ أي: ولا أعلم ما تعلمه؛ أي: مما انفردت بعمله، وقد حسَّنه هنا المشاكلة كما أشار إليه في الكشاف[14].
رابعًا: النفس بمعنى قُوى الخير والشر في الإنسان:
النفس بمعنى قوى الخير والشر لها صفات وخصائص كثيرة؛ منها: القدرة على إدراك الخير والشر، والتمييز بينهما، والاستعداد لهما؛ قال تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس: 7، 8]، وقال سبحانه: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: 10]؛ أي: بيَّنا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهناك إلى جانب الاستعدادات الفطرية الكامنة قوةٌ واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان، فمن استخدم هذه القوة في الخير وغلَّبها على الشر، فقد أفلح، ومَن أظلم هذه القوة وجناها وأضعفها، فقد خاب[15]؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10].
حقيقة النفس في القرآن الكريم:
بالنظر في التعريفات السابقة نرى القرآن الكريم يُحدِّث عن النفس، على أنها كائنٌ له وجود ذاتي مستقلٌّ، وبمعنى آخر فإن القرآن يخاطب الإنسان في ذات نفسِه، باعتبار أن النفس هي القوة العاقلة المدركة فيه، فيقول سبحانه: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [الشمس: 7، 8].
ويقول جل شأنه: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: 27 - 30].
ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ [يوسف: 53].
ويقول: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: 18].
ويقول سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].
ويقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: 6].
فالنَّفْس هنا وفي مواضع أخرى كثيرةٍ من القرآن، هي الإنسان العاقل المكلف، وهي الإنسان الذي يُتوقَّع منه الخير أو الشر، والهدى أو الضلال، ثم هي الإنسان بجميع مشخصاته جسدًا ورُوحًا.
إذًا فما النفس؟
يقول الدكتور عبدالكريم الخطيب في تفسيره - مجيبًا عن هذا السؤال -: والجواب الذي نعطيه عن هذا السؤال مستمَدٌّ من القرآن الكريم، بعيدًا عن مقولات الفلاسفة وغير الفلاسفة ممن لهم حديث عن النفس، وعلى هذا نقول: يُشخِّص القرآن الكريم النَّفْس ويجعلها الكائن الذي يُمثل الإنسان أمام الله، بل أمام المجتمع أيضًا؛ فالقتل الذي يصيب الإنسان هو قتل للنفس؛ كما يقول سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، ويقول جل شأنه: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]، وفي مقام القصاص تحسب ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: 45]،
وفي مقام التنويه بالإنسان، ودعوته ليلقَى الجزاء الحسن، تُخاطَب النفس وتُدعَى، فيقول سبحانه: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: 27 - 30]، والنفس في القرآن هي الإنسان المسؤول المحاسَب: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: 30]،
وإن بالفهم الذي يستريح إليه العقل في شأن النفس، هو أنها شيء غير الروح وغير العقل، وأنها هي الذات الإنسانية أو الإنسان المعنوي، إن صح هذا التعبير، إنها تتخلَّق من التقاء الروح بالجسد، إنها التركيبة التي تخلق في الإنسان ذاتيةً يعرِفُ بها أنه ذلك الإنسان بأحاسيسه ووِجدانه ومُدرَكاته، فالنفس هي ذات الإنسان، أو هي مشخصات الإنسان التي تنبئ عن ذاته، ولا نريد أن نذهب إلى أكثر من هذا، وحسبنا أن نُؤمِن بأن الروح مِن أمر الله، فلا سبيل إلى الكشف عنها؛ كما يقول سبحانه: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: 85]،
وأن النفس جهازٌ خفيٌّ عامل في الإنسان، فهي الإنسان المعنوي، ولهذا كانت موضعَ الخطاب من الله تعالى، كما أنها كانت موضع الحساب والثواب والعقاب[16]،.
فالنفس البشرية آية مبهرة من آيات الله تعالى في خلقه، سرها غامض وأغوارها تشي بتناقضات ومنازلَ ومهابطَ شتى بين القمم والسفوح، وقد نبَّه القرآن الكريم على البحث والتنقيب عن أسرارها قدر المستطاع؛ فقال الله تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: 21]، وذلك أمر في باب التبصر بالقلب لا مجرد النظر بالعين، تدبرٌ يُدرَك بالبصيرة النافذة إلى عمق النية لتزكيتها وإصلاح فسادها، فهذا هو الفلاح والنجاح الدائم الذي يورث رضا الله المولى؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى * يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى * وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى * فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: 34 - 41]، وأقسم الله تعالى أقسامًا متتاليةً على فلاح من أنصفها بالتزكية، وعلى خيبة من تركها لهواها؛ فقال الله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 1 - 10]، والنفس البشرية آية مبهرة من آيات الله تعالى، وهي لا تثبت على حال، ولا يقر لها قرار، متنقلة الأطوار بين معارجَ ومدارجَ بين الطاعات والمعاصي، والمرء لا يعرف على اليقين أين تكون نفسه؛ أفي مدرج علوي كالنفس المطمئنة أم في تسفل وانحطاط كالأمارة بالسوء.
وأغلى مراتب النفس هي النفس اللوامة؛ وهي التي أقسم الله بها فقال: ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: 2]، فاختُلف فيها؛ فقالت طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة، أخذوا اللقطة من التلوم، وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون، وهي من أعظم آيات الله، فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة - فضلًا عن اليوم والشهر والعام والعمر - ألوانًا متلونة؛ فتذكر وتغفل، وتقبل وتعرض، وتنيب وتجفو، وتحب وتبغض، وتفرح وتحزن، إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها؛ قال الحسن البصري: "إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائمًا، يقول: ما أردت بهذا؟ لمَ فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى أو نحو هذا الكلام".
وقال غيره: "هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه، فهذا اللوم من الإيمان، بخلاف الشقي؛ فإنه لا يلوم نفسه على ذنب، بل يلومها وتلومه على فواته"؛ [ابن قيم الجوزية، الروح، ص: (298، 299)، مؤسسة جمال، بيروت؛ بتصرف وانتقاء].
وذكر القرطبي في الجامع: "وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر: لمَ فعلته؟ وعلى الخير: لمَ لا تستكثر منه؟".
وقيل: "إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح؛ وعلى هذا يجيء القسم بها سائغًا حسنًا"، وقال الفراء: "ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانًا، والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن إساءته"؛ [الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص: 93، ج: 8، ط: 1، 2003م، بتحقيق/ هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض].
وأما النفس الأمارة فهي النفس المذمومة التي تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له؛ كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: 53]، وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة واللوامة، كما أكرمه بالمطمئنة، فهي نفس واحدة تكون أمارةً ثم لوامةً ثم مطمئنةً، وهي غاية كمالها وصلاحها، وأيَّد المطمئنة بجنود عديدة؛ فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها ويسددها، ويقذف فيها الحق، ويرغبها فيه، ويريها حسن صورته، ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه، ويريها قبح صورته، وأمدها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر، وجعل وفود الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية؛ [الروح، ص: 300؛ بانتقاء].
وقد استعاذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ظلمات النفس وأضرارها حينما تجنح إلى الأوزار والسيئات؛ فقال: ((... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له...))؛ [أحمد شاكر في مسند أحمد (4/ 264)، وقال: إسناده صحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما].
والملاحظ في حياة الكثيرين من الناس أنهم مصطلحون بتمام المعنى مع أنفسهم، ولا يجدون فيها عوجًا لطلب الإصلاح والتقويم؛ لأنهم ينظرون إلى أنفسهم بعين الرضا، وحينما يفكر أحدهم في مراجعة نفسه، فإنه لا يحاسبها إلا في أبواب المال والخسارات والمرابح الدنيوية العاجلة، أما محاسبتها لعتابها وإصلاحها، أو تقويمها وتجهيزها للآخرة - فذلك على الناس لا على نفسه، فنفسه في ظنه لا تفتقر أي تقويم أو علاج؛ توهمًا كاذبًا أنه قد بلغ حد الكمال في الفهم والتربية، مع أنه ربما كان مأوى العلل، وإنما يحاسب الخلق على الذر ويرى الهباءة في عين أخيه، ولا يستشعر الجذع في عينه؛ من فَرْطِ ظلمه لنفسه وانتقاصه للناس، وذلك كله ثمرة مصالحة النفس.
في باب التقويم:
وفي باب تقويم النفس عليه أن يحذرها ويخشاها في توثباتها ومطامعها، وأن يزجرها بتذكر الموت والمصير المحتوم، وبالفضيحة بين الخلق في الدنيا والآخرة إذا ما دعته إلى ريبة أو اقتراف محرم أو اكتسابه، وألَّا يطعمها من كل مرغوب حتى ولو كان مباحًا، ففي حبس النفس ما تشتهي رياضُ السلامة والنجاة من الآفات على حد قول من قال:
ومن يطعم النفس ما تشتهي * كمن يطعم النار جزل الحطب
وعلى المؤمن في باب التقويم أن يرغبها في فعل الحسنات، وارتياد آفاق الطاعات، ولا ينسى أبدًا أن يردد مقولة زوجة العزيز لما اعترفت على نفسها بحقيقتها؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: 53]؛ حتى تنقاد له نفسه وتسجن في حدودها المشروعة؛ لأنها لو تُرِك لها العنان جمحت وشردت، وإن قُيِّدت بقيود الشرع فإنها تسير إلى هداها وعافيتها وسلامتها؛ قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ((الكيِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله))؛ [سنن الترمذي (2459)، وقال: إسناده حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه]، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبركم بالمؤمنين؟ من أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب))؛ [الألباني في السلسلة الصحيحة (549)].
مواقف رائدة في باب المحاسبة:
عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: ((نادى عمر بالصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبض لي من التمر والزبيب، فأظل يومي وأي يوم، ثم نزل، قال عبدالرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك - يعني: عبت - قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني قالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها))؛ [محب الدين الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ص: 259، ج: 2، ط: 1، 2000م، دار المنار، القاهرة]، ومن مواقف عمر بن الخطاب أيضًا في مراجعة النفس ما نقله ابن القيم قال: "ذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم، فقال: أوَ كلما اشتهى أحدكم شيئًا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ [الأحقاف: 20]"؛ [ابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص: 166، دار الكتب العلمية، بيروت].
ومن معاتبات النفس الجادة نقف على خبر حنظلة بن حذيم الحنفي رضي الله تعالى عنه قال: ((لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأْيُ عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأيُ عين، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات))؛ [صحيح مسلم (2750)].
وبمثل ذلك كان أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يراجعون أنفسهم على الدوام، ويفرضون عليها غمار العزائم القوية حتى في أصعب الأوقات، حتى انقادت لهم؛ وهذه صورة بألوانها الطبيعية من أرض مؤتة يرويها والد عباد بن عبدالله بن الزبير الذي أرضعه رضي الله عنه يقول: "والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء، ثم عقرها، ثم قاتل القوم حتى قُتل، فلما قُتل جعفر، أخذ عبدالله بن رواحة الراية، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، وتردد بعض التردد ثم قال:
أقسمت يا نفسي لتنزلنهْ
طائعةً أو لتُكرهنهْ
ما لي أراكِ تكرهين الجنة
إن أجلب الناس وشدوا الرنة
لطالما قد كنتِ مطمئنهْ
هل أنتِ إلا نطفة في شنَّهْ
وقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه:
يا نفس إن لا تُقتلي تموتي
هذا حمام الموت قد صُليتِ
وما تمنيتِ فقد لقيتِ
إن تفعلي فعلهما هُديتِ
ثم نزل، فلما نزل، أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صلبك؛ فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقيت، فأخذه من يده فانتهش منه نهشةً، ثم سمع الحُطَمة في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قُتل..."؛ [الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 162)، وقال: رجاله ثقات].











.jpg)



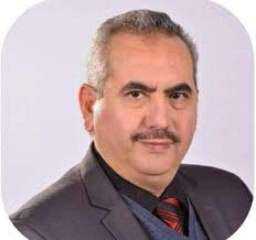


















.png)
